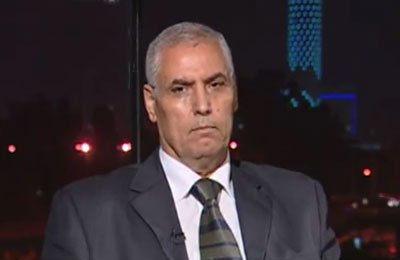لكل أمرٍ قواعد وأصول تحكمه، وخطوط حمراء تنظمه؛ حتى لا يخرج عن مساره الطبيعي وربما انقلب إلى أمر مغاير تمامًا؛ لأنه حتى الخلق الإنساني داخله شعرات افتراضية فاصلة والأمثلة لا تُحصى؛ فبين الاعتدال والشح شعرة، وبين الكرم والسفه شعرة، وبين الشجاعة والتهور الأخرق شعرة، وبين العبقرية والجنون شعرة.
إن بعض ما يجري على الساحة المصرية يتسمى بمسمى بعيدٍ عن واقعه تمامًا؛ فالمطالبات بحقوق مدعاة تتذرع بحق الطرح بينما هي في الحقيقة تمارَس كنوعٍ من فرض المطالبات قهرًا وجبرًا وبأساليب وممارسات لا تنتمي لحرية التعبير بقدر ما تنتمي لحرية التدمير، والاندفاع بالدولة لهاوية منطق الغابة، فالصورة العامة تشير لا إلى مطالب مع اتخاذ وسائل ضغط تدريجية بحيث تعطي أول الأمر فرصة للبحث والدراسة ولا تستعدي المجتمع عليها لو أنها لجأت إلى أعنف الوسائل مرةً واحدة خرقًا للشرعية وضربًا لهيبة الدولة في الصميم مع ملاحظة أمر بالغ الأهمية، وهو أننا إذا استثنينا فئات لا تمثل في مجموعها مليون مصري فإن باقي الخمسة والثمانين مليونًا لديهم مظالم متراكمة؛ بدءًا من الموظفين إلى الفلاحين إلى صغار التجار وانتهاءً بساكني القبور والمرضي بلا دواء ضحايا سياسات النهب العام التي سادت لأربعة عقود، وإذن فإن من يطالب بحق عليه أن يدرك أنه ليس وحده المظلوم، وألا يتوهم أن له وحدة أولوية العدل الناجز لقضيته!.
إن بعض ما يجري على الساحة من مشاهد إنما يليق بغابة لا بدولة، مع ملاحظة أن بالغابة أسدًا هو ملكها، ولها قانون هو قانون الغابة؛ فهي تسير وفق منطق وليست انفلاتًا وإلا فنيت كل الغابات لو قام الجميع على الجميع!.
لا أتحدث عن قطَّاع الطرق السابحين في أمان يوزعون الرعب ليلاً ونهارًا في كل مكان، ولا عن أولئك الذين فروا من السجون ولا يزالون طلقاء يعيثون في الأرض خرابًا وفي خلق الله ترويعًا، ولا أتكلم عن قيام مجموعة إخوة بخطف شاب وأمه وقتل الشاب أمام أمه، ثم الطواف بالأم عارية جهارًا نهارًا في أحد مراكز بني سويف- كما نشر- دون أن تتحرك الشرطة التي ترك بعض رجالها مهمة منع الجريمة وتفرغ لمنع قياداته من دخول مقار أعمالهم!!، ولا أتكلم عن اضطرار الناس المسالمين إلى قتل بعض عتاة المجرمين بأيديهم بعد أن شبعوا ترويعًا دون أن تلتفت إليهم الشرطة التي ما زالت الحاضر الغائب في أكثر الأحوال، وقد سبق بعض رجالها الجميع طلبًا لغنائم الثورة التي كانت الشرطة في عداوتها واستمات رجالها في قتل الثورة والثوار معًا، فلما نجحت كانوا في مقدمة من يطلب أرباح المشروع قبل أن يكون للمشروع عائد بعد! ولا أتكلم عن طرق صارت بمثابة قطعة من شيجاغو يحظر السير عليها مع حلول الظلام!.
لا.. ليس عن هذا البلاء أتكلم، وإنما أتكلم عن مشاهد أخرى وقعت من رجال قانون أو رجال في خدمة القانون.
أفهم أن لأمناء الشرطة وأفرادها مطالب، وأن عليهم- كسائر المصريين- مظالم وأفهم أن يطالبوا وأن يغضبوا، ولكن ما استعصى على فهمي تمامًا هو انقلاب حماة القانون- من المفترض أنهم كذلك- ورموز الانضباط إلى مطالبين بعزل وزير الداخلية قبل التفاوض، كما لا أفهم أن يقوموا بقطع الطريق بين محافظة شمال سيناء وبين مطار العريش، وقيام بعضهم بتحطيم مبانٍ في صالتي الوصول والسفر بمطار القاهرة الدولي، وقطع الطريق المؤدي إلى موقف بنها العمومي، ناهيك عن منع بعض مديري الأمن من دخول مقار المديريات وتقديم قائمة طويلة بالمطلوب عزلهم من الضباط؛ حتى يرضى الأمناء والأفراد!
وقد كنت أتحدث مع أحد كبار رجال الشرطة فقال لي: لقد صرنا أسرى بيد الجنود والأمناء!! كان صوته يشع إحباطًا ويأسًا!.
والسؤال: هل يملك المجلس العسكري الذي يدير البلاد عصا سحرية يحل بها في طرفة عين مشكلات أمناء الشرطة وأفرادها المتراكمة كمشكلات باقي المصريين؟ وهل يستطيع إسكان كل المشردين بلا مأوى؟ وهل سيعالج كل المرضى؟ ويوظف ملايين العاطلين عن العمل؟
يزوج ملايين من فاتهم قطار الزواج؟ وهل سينصف كل مظلوم؟ أم سيتأخر في ذلك كما تأخَّر في إصلاح حال الأمناء والجنود؟
وحتى لو كان ذلك قد تم فعلاً فهل تدمير المطارات وقطع الطرق جزء من حرية التعبير ورفع المطالب؟ وهل المنطق المرتجف المرتعش لوزارة الداخلية ووزيرها الطاعن في السن- مع كامل الاحترام لشخصه وتاريخه النقي- هل هذا المنطق سوف يحل المشكلة أم سيزيد من تفاقمها؟ ثم إنه ما دامت الحقوق تؤخذ من خلال تحطيم المباني وقطع الطرق أليس من المعقول أن تفكر كل الجهات والفئات بنفس الأسلوب؟ إنني أجزم- مقدمًا- بفشل أسلوب اللواء العيسوي؛ لأنه عندما يخرج رجل الشرطة- الذي يفترض أنه نشأ على الانضباط العسكري- على القانون ويحطم المنشآت ويقطع الطريق فإن آخر منطق يصح التفكير فيه هو مكافأته لا معاقبته، وسوف ترى يا سيادة اللواء لا في المدى البعيد؛ بل في المدى القريب نتائج سياستك المهادنة في الكليات والأصول، وليس بي ذرة شك في أن رحيل اللواء العيسوي واقع في القريب بعد أن وصلت سياسات وزارته تلك إلى جعل التمرد والخروج على القانون علنًا قاعدة، لا في الشرطة وحدها، ولكن عند شرائح المجتمع المختلفة.
لقد دخل العيسوي ومن ورائه الدولة في لعبة شد الحبل مع أمناء الشرطة وأفرادها، وما دام قد قبل بدور الطرف الذي عليه أن يسلم بضعفه فإنني أقول له من الآن: إن الطرف الآخر في اللعبة لن يكف عن جرجرة هيبة الوزارة والدولة كلها- كما يجري- للطرف المهزوم في لعبة شد الحبل، وسترى في قابل الأيام أن ذلك واقع لا محالة؛ لأنه كان أمامك خيار يحتاج إلى خيال فاتبعت ما تصورته أسهل الحلول.. كان أمامك فرصة تجنيد خريجي الحقوق، وهناك منهم جيوش، خاصةً من سبق تجنيدهم بالقوات المسلحة؛ فهؤلاء مدربون تقريبًا للقيام بمهام الأمن بروح جديدة بعد تلقيهم دورات شرطية لا تحتاج سوى أسابيع، ولكن منطق المهادنة أبى إلا أن يصل بنا إلى ضياع الانضباط (الميري) ضياعًا ينذر بشر مستطير!.
وأختم المشهد الكئيب بأنني لست ضد إنصاف مظالم أمناء الشرطة؛ بل إن من حقهم- ككل المصريين- أن ينعموا بحياة كريمة، وأن يتقاضوا رواتب تكفل لهم تلك الحياة، ولكني بالقطع واليقين ضد الخروج على القانون وتحطيم المنشآت العامة، وقطع الطرق، وضد أن يكون ذلك السلوك محل ثواب بدلاً من أن يكون متبوعًا بحساب وعقاب، وأتمنى أن تثبت الأيام خطأ ما أنا موقن من وقوعه من شيوع الخروج على القانون مع مكافأة الخارجين، ولو كنت مكان العيسوي ما وافقت على مطلب واحد يبدي بهذه الطريقة ولو كان آخر ما أفعله في حياتي؛ لأن لَيَّ الذراع يجب أن يقابل بنفس المنطق وإلا انهارت الأصول؛ ولأن التفريط في المبدأ في سبيل المصلحة يهدر المبدأ ويهدر المصلحة يقينًا يقينًا!.
ونأتي إلى المشهد الثاني، وهو ما وقع في ساحات الكثير من المحاكم من المحامين.
وأسجل- بشكل مبدئي- أنني ضد أي نص ينال من حصانة المحامي أو يهدده خلال أداء رسالته، فالمحاماة ليست مجرد مهنة؛ بل هي رسالة حقيقية، وليس أدل على كون المحاماة رسالة في الأساس أن المحامين هم أكثر أصحاب المهن الحرة تقديمًا لعملهم بلا عائد، وكان- وما زال- هناك رجال وقامات كقامة المرحوم الأستاذ نبيل الهلالي الذي كان الكثير من المظلومين يُفاجأ به سابقًا حتى أهله إلى زيارته والوقوف معه دون انتظار لمقابل مالي، وقد عاينت في عملي بالقضاء محامين يبادرون وبشكل يومي بالحضور والترافع عمن يعتقدون أنهم مظلومون بلا مقابل، والمحامون هم جزء من منظومة السلطة القضائية، والحصانة ليست لأشخاص وإنما لحسن أداء رسالتهم.
وبرغم إيماني برسالة المحاماة وتقديري للمحامين؛ فإنني لا أفهم بعض الذي جرى منسوبًا إليهم ولا أتعاطف معه؛ بل أرفضه رفضًا قاطعًا جملة وتفصيلاً.
إن من حق المحامين أن ينتفضوا؛ بل من واجبهم أيضا كلما رأوا في الأفق أي احتمال للنيل من حقهم في مناخ ملائم لأداء رسالتهم، ولكن هل من قبيل التعبير عن الرأي أو المطالبة بحق تغلق المحاكم ويمنع دخول القضاة إليها عنوةً وقهرًا وإهدارًا لفكرة القانون ونسفًا لهيبة الدولة؟ وهل يليق وقوف المحامين ومنع القضاة من دخول المحاكم مع فواصل من الإهانات؟ وهل بهذا الطريق تؤخذ الحقوق؟ لقد نقلت إلى رواية من شهود عدول عن سباب بعض المحامين لقاضي، وهو يهم بدخول المحكمة حتى صاح فيهم محام قائلاً: "اتركوا هذا القاضي فهو يحسن معاملة المحامين"!!! هل هذا معقول؟ وهل بقيت للدولة هيبة بعد الاعتداء على القضاة والقضاء الذي هو أبرز تعبير يومي عن سيادة الدولة؟، وماذا لو علق القضاة- كما يطالب بعضهم- جلسات المحاكم وتوقف جهاز العدالة عن أداء دوره ما دامت الدولة عاجزة عن توفير الحماية للقضاة وعن الدفاع عن هيبتها، وقد علَّقت بعض المحاكم جلساتها بالفعل؟ هل تربح المحاماة كثيرًا؟ وهل هناك من الأصل محاماة دون محاكم؟ وهل تبقى للمحاماة كرامتها عندما تهدر كرامة القضاة والقضاء؟ ثم ما ذنب أصحاب الحقوق في القصة كلها والطبيعي أن المحامين هم مَن يدافع عن تلك الحقوق لا مَن يسد الطريق في وجه طلابها!
أليس من حقنا أن نترحم على أيام كان المحامون أول مَن يدافع عن القضاة والقضاء؟, إنني أستميح القارئ عذرًا في ذكر وقعةٍ كنتُ طرفًا فيها, كنتُ أُحقق قضية كبرى استمرت شهورًا عندما كنت وكيلاً للنائب العام، وكان أحد المحامين الحاضرين عن بعض المتهمين هو المرحوم الأستاذ حافظ بدوي الذي كان قبل ذلك رئيسًا لمجلس الشعب عندما كنت لا أزال تلميذًا صغيرًا, وكنت في عمر أصغر أبنائه, كانت التحقيقات يومية وعلى مدى نحو عشر ساعات في اليوم الواحد, كنت كلما تعبت من طول جلستي، ووقفت لأستعيد نشاطي هب الرجل واقفًا، وكنتُ أشعر بحرجٍ شديد, ورجوته في كل مرةٍ ألا يفعل دون أن يستجيب, وكنت إذا غادرت المكتب هبَّ واقفًا وإذا دخلت هبَّ واقفًا, وتصادف أن رنَّ الهاتف وطلب إلى أحد أقاربه أن يُكلمه فأعطيته سماعة الهاتف فقال لمحدثه جملة واحدة (قلتُ لا يطلبني أحد وأنا في النيابة)، ثم أنهى المكالمة وراح يعتذر لي, وتصادف أن أُقيم حفل لضابط شرطة كبير منقول، وحضرتُ الحفل وبه حشد كبير من الحضور، وكان هو- رحمه الله- من أُقيم الحفل برعايته, فقدمني الأستاذ الكريم الخلوق حافظ بدوي علي الحضور جميعًا، وأجلسني إلى جواره، وكان يناديني أمام الجميع (سيادة الريس)! وما كان من الأستاذ الكريم هو منطق جيله من العمالقة الكبار!
أليس مما يُدمي القلب أن يرحل جيل حافظ بدوي ويخلفه جيل يغلق أبواب المحاكم في وجوه القضاة ويمعن في إهانتهم؟!
ولستُ أنكر أن هناك دواعي حقيقية لغضب المحامين, وموقفي من قضايا؛ مما أثاره المحامون معلن عبر الصحف والفضائيات سواء عن تطهير القضاء أو مظالم تعيينات القضاة, وليس عن هذا أتحدث وإنما عن النهج الفاجع والأسلوب الذي يستحيل الدفاع عنه لأنه لا يليق تحت أي ظرف تسويغ ما جرى.
إن ما وقع في بعض ساحات المحاكم هو طامة كبرى, والأسوأ منها أن تمر دون حساب, وأقول للدكتور عصام شرف وحكومته خير لكم أن تمسكوا بزمام الأمور جيدًا، وتحافظوا على هيبة الدولة أو أن ترحلوا؛ لأن الخرق آخذٌ في الاتساع على الراتق، ولأن سياسة التغاضي والانحناء أمام العواصف لن يوقف العواصف، بل يزيد القائم منها ويغري بالمزيد, وأقول للرجل إن أداء حكومتك ضعيف مهتز يغري بانفلات المجتمع كله إلى هاوية سحيقة, وبرغم كامل احترامي لشخص رئيس الوزراء ووزير الداخلية فإني أري أنهما ليسا رجلي المرحلة؛ لأن اللين وحده دون بدائل سوف يعمق الأزمات على النحو الذي نرى.
إنني أطالب بتحقيق قضائي في كل ما وقع ومحاسبة كل مَن حرَّض أو شارك على أي نحو في تلك الطامة الكبرى, وأحذر من أنه إذا لم يتم الحساب الرادع وأنه إذا أصبح دخول القاضي محكمته رهينًا برضا الراضين وغضب الغاضبين فسوف يفقد القضاء هيبته تمامًا وإذا فقدت المحاكم هيبتها استحال أداء رسالتها؛ لأنه كيف يصدر القضاة حكمًا بإعدام تاجر جلب مخدرات ومن حوله جيش من المستعدين للخروج على القانون سائرين على سنة من أهانوا القضاة والقضاء ولم يحاسبوا, أما إذا كانت الدولة مصممة على سياسة الانحناء للواصف والتخلي عن الدفاع عن هيبتها وتركت القضاة مكشوفين أمام مَن يريد الاعتداء فإن من الأفضل تمامًا لحكومة الدكتور شرف أن تُغلق المحاكم وأقسام الشرطة نهائيًّا؛ لأن القانون يقوم على تطبيقه قضاة، ويقوم على تنفيذه رجال شرطة، وسوف تؤدي سياسة اللين الذي لا يعرف حزمًا إلى توقف القضاء والشرطة عن أداء رسالة تطبيق وتنفيذ القانون, وعلى الحكومة- ساعتها- أن تُوفِّر رواتب القضاة ورجال الشرطة، وتُوزّع السلاح على المواطنين ثم تستقيل هي بعد أن تعلن عن تحول مصر من أول دولة مركزية منظمة في التاريخ الإنساني إلى غابة!.