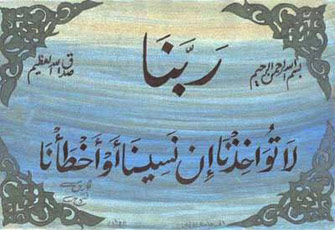عن أبي الدرداء- رضي الله عنه- قال: "كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبًا، فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل، حتى أغلق بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو الدرداء ونحن عنده: فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "أما صاحبكم هذا فقد غامر".
قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلَّم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقصَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر.
قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله، لأنا كنت أظلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل أنتم تاركو لي صاحبي، هل أنتم تاركو لي صاحبي؟، إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير: باب تفسير قوله تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) (الأعراف: من الآية 158). انظر: فتح الباري (8/ 303) ح 4640، وأخرجه أيضًا في كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذًا خليلاً". انظر: فتح الباري (7/ 18) ح 3661.
الخطأ طبيعة بشرية:
هذا الحديث الشريف يوضح الطبيعة البشرية فهي تخطئ وتصيب، وليس أحد معصومًا إلا النبي- صلى الله عليه وسلم- فأبو بكر وعمر كانا على رأس الصحابة ومن فضلائهم وأكثرهم قربًا من النبي- صلى لله عليه وسلم- ومن خاصته ووزرائه وخلفائه من بعده، ومع ذلك حدث بينهم من سوء التفاهم ما أثار الغضب بينهم وغير من نفسيهما.
ولا يظن أحد أن هذا قدح في فضلهما ونقص في شأنهما وإنزالٌ لهما من قمة الصلاح والخير، فهما تصرفا من منطلق ما ركب الله فيهما من نوازع بشرية قد تدفع الإنسان للغضب، وتجره إلى الخطأ.
كما أنهما وغيرهما من الصحابة لو كانوا لا يخطئون، ولا يصدر منهم إلا كل جميل محمود لأصبحوا ملائكة يمشون على الأرض، ونماذج مثالية يعز وجودها ويندر تكرارها، ولن نكون قادرين أن نقتدي بهم لأننا لا طاقة لنا على ملازمة الطاعة والعصمة من الزلل.
ولو كانوا معصومين فلا ميزة لهم ولا فضل فيما يقومون به من أعمال عظيمة وأحوال مجيدة ومقامات فريدة؛ لأنهم جبلوا على ذلك، وفطروا على الطاعة، وانتُزِعت من نفوسهم بواعث الشر ودوافع الغريزة، إنما الفضل كله أن يجاهد الإنسان نفسه ويهذبها وينتصر عليها، فقد مدح الله تعالى من يضعف أمام شهوته ويستجيب لبواعث الشر ثم يفيق إلى رشده ويعود إلى صوابه فقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (201)) (الأعراف).
وقال أيضًا: (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)) (آل عمران).
الاعتراف بالخطأ والاعتذار منه:
ففي الحديث الذي معنا أن أبا بكر أغضب عمر إثر نقاش حاد وخلاف في الرأي وآثر عمر الانصراف ولم يقابل الإساءة بمثلها، لكنَّ أبا بكر لم يترك عمر يشتد به غضبه فلحقه يعتذر إليه ويستسمحه ويطيِّب خاطره لكنه أغلظ في الرد، وبلغ به انفعاله أن أغلق الباب في وجه الصديق، وهنا أدرك عمر خطأه؛ حيث لم يقبل الاعتذار فذهب إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- وقصَّ عليه الخبر لعله يصلح بينه وبين أخيه ورفيق دربه أبي بكر.
انظر يا سيدي إلى هذين العظيمين كيف تربيا على مائدة النبوة الكريمة، لم يجد أبو بكر حرجًا في نفسه ولا نقصًا في ذاته ولا احتقارًا لشأنه أن يعترف بخطئه ويلح في الاعتذار منه، بل إذا دققت النظر وأمعنت في حقيقة الأمر لعلمت أن هذا الفعل هو انتصار على النفس التي تُري الإنسان أفعاله على غاية الكمال وسلوكه في نهاية الجمال ثم هي تبرر له الخطأ وتبحث له عن أعذار، كما أنه برهان ساطع على الشجاعة التي يتحلى بها المخطئ إذ يعترف بقصوره، وهذا من فعل النبلاء وشيم الفضلاء وعظمة الرجولة وكمال الإنسانية.
وفي تاريخنا أمثلة كثيرة نذكر منها:
1- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتًا، فقال: "ما هذه الأصوات؟" قالوا: النخل يؤبرونه يا رسول الله، فقال: "لو لم يفعلوا لصلح"، فلم يؤبروا عامئذٍ فصار شيصًا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا كان شيئًا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإذا كان شيئًا من أمر دينكم فإليَّ". رواه الإمام أحمد في المسند 6/ 123 وفي رواية أخرى:
عن رافع بن خديج قال: قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُأبِّرون النخل (يلقحون النخل) فقال: "ما تصنعون؟" قالوا: كنا نصنعه، قال: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا"، فتركوه فنفضت (يعني أسقطت ثمرها)، قال: فذكروا ذلك، فقال: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر" رواه مسلم.
فالنبي- صلى الله عليه وسلم- قال رأيًّا بناءً على اجتهاده الشخصي، فقد ترجح عنده أنهم لو تركوا النخل بدون تلقيح لكن أدعى لزيادة الثمر، ووفر عليهم جهدًا ومالاً، فلما أخبر أن النخل شاصت وبان له خطأ اجتهاده، وأن رأيه جانبه الصواب أعلن- صلى الله عليه وسلم- أن ذلك لم يكن بناءً على وحي من الله تعالى بل هو رأي قاله بمحض بشريته التي يجوز عليها الخطأ والصواب في الاجتهاد والاستنتاج، ولم ير- صلى الله عليه وسلم- في ذلك انتقاصًا من نبوته وطعنًا في رسالته، بل كان يرى أن البيان واجب ليعلم الناس أن أمور الدنيا القائمة على الخبرة والممارسة والدراسة والمعرفة رأيه فيها كرأي غيره، ممكن أن يصيب وممكن أن يُخطئ، وإن خطأ الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيها لا يقر ولا يعد ذلك تكذيبًا للنبي- صلى الله عليه وسلم.
2- روى مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما أكثركم في صدق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، فقالت أما سمعت الله يقول: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا) (النساء: من الآية 20).
قال: فقال اللهم غفرًا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: "أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب" ساقه الحافظ ابن كثير في تفسيره من طريق أبي يعلى بسنده ثم قال ابن كثير في آخره. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل إسناده جيد قوي. (تفسير ابن كثير. الآية 20 من سورة النساء).
هذا عمر العظيم لا يجد حرجًا في نفسه أن يصعد المنبر ويعلن أمام رعيته أنه أخطأ في فتواه، وأنه قد تراجع عنها؛ لأنه لما بان له الحكم بالدليل كان وقافًا عنده لم يقل أيتعلم عمر من امرأة؟ لم يدر في خلده أنه بهذا التراجع قد نزلت مرتبته في نفوس رعيته؟ لقد كبر عمر في نفوسنا جميعًا، وعلمنا فضله، وأن الحق عنده أولى من نفسه، وأن الحفاظ على الدين أغلى من ذاته، وأن المبادئ في نفوس النبلاء العظماء أعز من كل شيء.
ألا يتعلم حكامنا وأصحاب المسئولية فينا أن يصارحوا شعوبهم بأخطائهم، ويطلبوا العفو منهم، وأن يتنازلوا عن قناعاتهم لأجل المصلحة العامة.
3- كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: لاَ يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ".
4- عن محمد بن كعب القرظي، قال: سأل رجل عليًّا عن مسألة فقال فيها. فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا.
فقال علي، رضي الله عنه: "أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم" رواه الطبري في تفسيره، برقم "19593" 7/ 263.
5- وكان العلماء والفقهاء إذا استفتوا في مسألة وبان لهم خطأ اجتهادهم رجعوا على الفور وفاءوا إلى الحق وأعلنوا ذلك دون حرج، ولقد أحسن الحسن بن أبي زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة فيما بلغنا عنه أنه استفتي في مسألة فأخطأ فيها ولم يعرف الذي أفتاه فاكترى مناديًا فنادى أن الحسن بن أبي زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن أبي زياد بشيء فليرجع إليه، فلبث أيامًا لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه أخطأ وأن الصواب كذا وكذا والله أعلم (أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح جـ1 ص 46).
ألا يتعلم مَن يتصدرون اليوم للفتوى أن يراجعوا فتواهم، وأن ينصتوا لمن يخالفهم فيها ويملكوا الشجاعة الحقة ويقولوا: "لقد أخطأنا في كذا وأصاب غيرنا" فيفوزوا بثقة الناس وتقديرهم.
قبول اعتذار الخطأ:
وهذا الحديث يعلمنا أن من شيم الكرام، ومن أخلاق المؤمنين أن نقبل اعتذار من أساء إلينا ونقدر فيه هذه الشجاعة الأدبية؛ فإنه مما يزيد المواقف تأزمًا ويوغر الصدور ويديم العداوة أن لا نتسامح مع المخطئين في حقنا، فقد رأينا أن عدم قبول عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- معذرة أبي بكر كاد أن يوقد نار العداوة لولا أنه ندم وذهب إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- ليصلح بينهما.
وللأسف شاهدنا أناسًا حظهم من السماحة قليل وبضاعتهم من تألف الناس ضئيل، لا يقبلون عذر معتذر وتبقى العداوة والخصومة في نفوسهم ما بقوا أحياء يرزقون، بل إنهم يورثون هذه الأحقاد ويكلفون أبناءهم وأحفادهم بتركة ثقيلة هم في غنى عنهم.
ونحن نقول لهؤلاء:
ماذا يفعل الإنسان في طباع مرذولة، وعادات مشئومة ولد بها ونشأ عليها دفعته لتصرف أحمق وسلوك أهوج، ثم لما هدأت نفسه وعاد إلى رشده أدرك جرم خطئه فجاء معتذرًا.
ثم إنك إذا لم تقبل اعتذار أحد فهل أنت لا تخطئ؟ وإذا أخطأت ألست تود أن يسامحك من أخطأت في حقهم إذا كنت تريد ذلك لنفسك فلماذا تعسرها على غيرك؟ أليس من علامات الإيمان الصادق أن تحب لنفسك ما تحبه لإخوانك؟
الاعتذار في الحال:
وفي الحديث ضرورة الاعتذار فورًا، فإن التأجيل له أبعاد خطيرة؛ حيث يعقّد الأمور، ويضخّم الإساءة، ومما يعين على قبول العذر أن تذهب إلى صاحبك في بيته وتجلس معه وتفاتحه في الأمر ففي هذا تقدير له وإظهار لقدره، فأبو بكر ذهب إلى عمر في بيته، وعمر ذهب إلى أبي بكر في بيته، فلما لم يجده ذهب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فالاعتذار لا يكون في التليفون ولا بإرسال خطاب له، أو توسط أحد بينك وبينه، كل ذلك قد يؤخر الصلح، لا بد إذًا من المصارحة والمواجهة وطلب العفو والصفح.
والله الموفق.